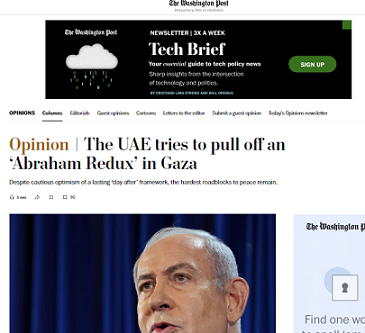مقدمة لزومية: في ضرورة العلم الإنساني وجدواه
في العشرين من نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للفلسفة، وهو ما يعني أن العالم أجمع مازال يرى أن للفلسفة ضرورة في عصرنا الراهن، رغم بزوغها منذ لحظة الميلاد الأولى للإنسانية، وذلك بسبب الدور التنويري الذي اضطلعت به في بناء الحضارة، وفي رقي للعقل الإنساني من غياهب الجهل والظلم وفي سعيه نحو الحرية وتحقيق العدل.
وفي سبيل هذه الغايات كان للفلسفة دائماً أن تسلك طرقاً واعرة في مجمل القضايا التي اشتبكت معها، كأصل الوجود الإنساني، ودور العقل البشري والإرادة الإنسانية في تجاوز خطايا الظلم والعبودية في حق البشر، من خلال طرح معايير لبنية أخلاقية استقرت عليها الأمم، والمجتمعات أحدثت تحولاً كيفياً في الارتقاء من عصور القوة والطغيان، إلى عصور النهضة والتحرر.
وبسبب هذه الغايات، ظلت الفلسفة، وظل الفلاسفة، قيد الاشتباه حقباً عديدة لدورها ولأهميتها في إيقاظ الوعي لعامة الناس، بسبب الحصار الذي مارسه القابضون على عقول الشعب من رجال الدين والسلطة، بإعتبارها نوعاً من الزندقه، التي تبعد الإنسان عن الإيمان الصحيح حتى عصر التنوير، الذي آمن بالعلم وبالعقل المؤسس له على أيدي فلاسفة التنوير، لتصبح الفلسفة حتى يومنا هذا هي رهان المستقبل لأي أمة تريد التحرر من أثر التخلف الثقافي والاجتماعي، والإيمان بدور العقل في مواجهة كل ما من شأنه تزييف الوعي المجتمعي وإعاقه الحراك الاجتماعي من أجل التغيير إلى واقع أفضل.
وكما قدم العالم الغربي فلاسفة أمثال: أفلاطون، وسقراط، وأرسطو، وهيجل، وديكارت، وماركس، قدمت الحضارة العربية الكندي، والفارابي وابن سينا، وابن رشد، وابن عربي، وابن خلدون، والمعتزلة، وإخوان الصفا، لقد كان هؤلاء الفلاسفة بما صاغوه من أفكار ورؤى ونظريات هم عصب التنوير من أجل إعلاء الإنسانية جمعاء في مواجهة المعضلات، والمشكلات التي واجهتها وهو ما يعني أننا مازلنا بحاجة إلى الفلسفة باعتبارها رؤى عقلية خالصة، من أجل مواجهة المشكلات التي يطرحها الآن التقدم العلمي والتكنولوجي، الذى فرض معضلات وتحولات علينا التصدى لها من منطلق عقلى ومعرفى متجدد لن تقدمه إلا الفلسفة.
إن جوهر الفلسفة وأهميتها، لا يكمن فقط في كونها رؤى عقلية خالصة منفصلة عن الواقع، في مواجهة إشكالياته، ولكنه يكمن في استجابة الفلسفة في كل حقبة إنسانية إلى النمو المعرفي الذي وصل إليه العقل في قطيعة معرفية عن الرؤى التي سادتها قبلاً، الأمر الذي يجعلها تمثيلا حقيقيا للتعبير عن هموم البشر، على الصعيد العلمى، بل والحياة اليومى، ويدلل على ذلك أنه مع انطلاق العقل الإنسانى، وتأسيس المنهج العلمى فى دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية، تحررت الفلسفة من ذلك الأسر الذى أحاطها بالرؤى المثالية المتعالية على الواقع، والتى اصطبغت بها منذ البدايات الأولى، إلى ما اعتبر إنجازاً عقلياً آخر، قدمته الفلسفة العلمية، جدلية المنهج، مادية التصور، فى دراسة المجتمع بمكوناته الطبقية، وقواه المسيطرة فى تعاضد، وربط بين العقل وما يطرحه، وجود البشر فى إطار من التاريخ المحدد، من خلال نقد الأسس التى قامت عليها المثالية الخالصة لفهم الواقع وتفسيره، باستخدام المنهج العلمى، الذى مهد الطريق للفهم الواعى للظواهر الإنسانية، الأمر الذى يبرر استمرارية حاجتنا إلى الفلسفة من أجل إيقاظ الوعى واستدامته فى مواجهة التيارات الظلامية والغيبية، التى تدعم العبودية والاستبداد، وتقود إلى التحرر من كل أشكال الظلم الاجتماعى.
وقد تكون حاجتنا إلى الفلسفة، ومازالت تطرح نفسها على المناخ الثقافى فى مصر منذ مطلع عصر النهضة حتى اليوم فقد كتب محمود أمين العالم عام 1995م في مجلة المصور المصرية مقالاً بعنوان "بلاش فلسفة"، يقول: (ما أعرف شيئاً أخطر على مجتمعاتنا من سيادة هذا التعبير (بلاش فلسفة) ذلك أننا بحاجة إلى أن نقف موقفاً نقدياً، وواعياً من الفكر السائد في مجتمعنا، وهو ما من شأنه أن ينقذنا من تخلفنا، في ظل ما حققه الغرب الذي لم تنقذه إلا الفلسفة من حبائل التخلف، فهذه الفلسفة هي القادرة على مواجهة ما يتميز به العربي من سيادة الثوابت الأصولية، والثنائيات، والتعميمات المطلقة، والإسقاطات، والأيديولوجيا).
ليست الفلسفة وحدها هى المطلوب لتجديد ثقافتنا، ولمواجهة التحديات التى يفرضها الواقع المتغير دوماً، باعتبارها من العلوم الإنسانية التى تزداد حاجتنا لها، فإن علوماً إنسانية أخرى لا تقل أهمية عن الفلسفة، بل تمثل صلب العلم الإنسانى ذاته، بما تقدمه من وعاء للوعى، والفهم للمجتمع وتطوره، يأتى علم التاريخ وفقاً لما أفاض به ابن خلدون في معرض تأسيسه لعلم الاجتماع، أن علم التاريخ ومنهجه الذي استحدثه يمثل ضرورة معرفية لإنقاذ الحضارة الإسلامية من كبوتها، وانتكاساتها، شريطة أن ينهض على أسس نقدية، لا يستند إلى المرويات، والأخبار المغلوطة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون الرجوع إلى الوجود الاجتماعي للبشر وعلاقاتهم الاجتماعية، الذي يشكلها هذا الوجود ويتفاعل معها، بما يسمح ببناء علوم حقيقة للاجتماع الإنساني، ومن ثم فإن المرتكزات العلمية لتأسيس علم التاريخ لا ينبغي أن يكون جل إهتمامها، الاستغراق في الماضي، وإنما تتحدد مهمته الأساسية في تقديم فهم ورؤى للمستقبل، من خلال إعادة استنهاض الذاكرة الجمعية للأمم التي تمثل أداة تحدي لمواجهة الواقع الآني، هذه الذاكرة تبقى حية دوماً تستبقى المفيد من قيم الماضي وتستنكر مداره، في ضوء طبيعة التطور على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
علم التاريخ إذن مهمته المساهمة في دفع الوعي لدى الجماهير، وهو ما يؤدي إلى تجديد الوعي بالتاريخ، وأهميته في التفسير، والتحليل، والتنبؤ، وتلك المهمة هي ما يدخل في صميم عمل الثقافة التي ترتبط بتاريخ المجتمع وأماله، وتطلعاته، ورؤاه للعالم، مما يجعله مثله مثل كل العلوم الإنسانية تُعد منطلقاً عقلياً وفكرياً لوضع مداخل تسهم في النهوض على كافة الأصعدة.
وإذا كانت الفلسفة، وعلم التاريخ باعتبارهما علوماً تحظى بهذه المكانة في سلم الإرتقاء الإنساني للمجتمعات، فإن علم الاجتماع في أهميته يكاد، بل يقارب في ضرورته وعلو مكانته، مالم تحظ به أياً من العلوم الإنسانية الأخرى، تلك العلوم التي لا يمكن أن تستقيم نظرياتها المفسرة، للظواهر المرتبطة بها دون الولوج إلى السياق الاجتماعي التاريخي الذي يبعث فيها سوسيولوجيتها، التي تمنحها الخصوصية المعبرة عنها والتي تمنحها صفتها العلمية.
وعطفاً على إنجاز علمى لتطور تلك العلوم، وتعدد تخصصاتها وأهميتها فى دراسة الجوانب المختلفة للبنية الاجتماعية، يأتى علم الاجتماع القانونى، على سبيل المثال الذى قدم أعظم إنجاز للبشرية، دفع إلى التغيير والثورة والتمرد على أوضاع الظلم الاجتماعى، بعد أن كانت البشرية، لا ترى بأسا لقرون طوال، أن القانون الطبيعى، أو الإلهى هو الذى يحكم البشر، لقد كانت سيادة هذا الفهم المغاير للقانون هو ما أرسى خطاباً قانونياً جديداً مهد للثورة وجعل منها تبريراً اجتماعياً ضد عدم الشرعية القائمة التى فرضها مغتصبو السلطة فى المجتمع بحكم القانون الإلهى.
ونفى علم الاجتماع القانونى، فى تفسيره القانون على ما يطلق عليه بالاستقلال النسبى فى علاقته بالبنية الطبقية فى المجتمع باعتباره معبراً عن مصالحها، ومصالح بناء القوة فيها، والتى تفرضها على عموم الناس، مما قدم إسهاماً فى التمييز بين فلسفات القوانين التى تصدر لصيانة الحريات والحقوق، وأخرى لتقيدها، وهو ما يؤسس لدراسة توجهات البنى التشريعية للمجتمع على أسس علمية واجتماعية.
العلم الإنسانى والعلوم الإنسانية كافة بالمعنى السابق تمثل خطابا ثقافياً فى المجتمع لا يجوز الانتقاص من دوره وأهميته فى حياة الكون، بل والبشرية بأسرها، وإلى مزيد من الطلب عليها، وانتشار تدريسها فى أروقة الجامعات وفى المدارس، لا إلى إلغائها ومصادرتها، وجبر العقل على التقليل من شأنها وأهميتها بالنسبة لنا، وبالنسبة لشبابنا من الخريجين فى أقسام الكليات المختلفة مثل الآداب والحقوق والتجارة، كما يلوح الخطاب السياسى اليوم لأنها لا تدر دخلاً على دارسيها، بسبب عدم توفيرها لفرص العمل فى سوقه التى تعانى من البطالة.
حاجتنا إلى العلوم الإنسانية فى عصر العولمة:
لسنا بحاجة فى هذا المقام إلى إثبات العلاقة الوثيقة بين العلوم الإنسانية، وبين عمليات التغيير، وهى تلك العلاقة التى وعتها المجتمعات البشرية فى لحظات تحولها وتغييرها، بل أن تلك العلوم قد نشأت، وظهرت إلى حيز الوجود، ومنها تحديدا علم الاجتماع لحظة ميلاد التحولات الكبرى إبان الثورة الصناعية، والفكرية فى أوروبا غرباً، كما أن ميلادها كان وليداً لأزمة معرفية، وبنيوية، على يد ابن خلدون شرقاً وفى الغرب كما فى الشرق، فإن بزوغ العلوم الإنسانية قد تزامن وترافق مع الأزمات الكبرى فى تاريخ الإنسانية.
كما لا نستطيع أن ننكر في المجتمع المعاصر أن الجامعات الأمريكية في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، قد لعبت دوراً مهماً في توجيه الفكر الإنساني في الجامعات، وعمليات البحث الإجتماعي علي مختلف الأصعدة إلي ما يرسخ الإتجاهات والقيم التي يتبناها السوق الحر والاقتصاد الرأسمالي.
وقبل تأسيس الجامعة المصرية، وقيام أقسام الاجتماع بها، نجد أن الفكر الاجتماعى قد لعب دوراً كبيراً فى تجاوز الخطاب الثقافى والقيمى، الذى ساد فى المجتمع المصرى قبل بداية العصر الحديث، فلقد أبدى هذا الفكر، اهتماماً بقضايا حقوق المرأة، والسفور والحجاب، وتعدد الزوجات، وتعليم المرأة، وموقف الدين الإسلامى فى كثير من الأفكار الأوروبية، ومن الموقف من الحداثة، أو ما عرف بالأصالة والمعاصرة، فضلاً عن تبنيه بعض قضايا الإصلاح الديني، ومن بينها إصلاح التعليم الأزهري.
ومن المؤكد أن دخول علم الاجتماع إلى الجامعات المصرية، كان وليداً لحالة التثاقف التى أوجدها هؤلاء المفكرين الاجتماعيين، ومدى ما ساهمت به فى تغيير الكثير من القيم والثقافة السائدة، وكان دخوله بداية بلورة أو مقاربة للأفكار التى تصلح لدراسة هموم المجتمع وإشكالياته. وثمة شواهد ماثلة لأهمية العلوم الإنسانية، ومن بينها علم الاجتماع فى ما يسمى بعصر العولمة، وضرورة استمراره، وتطور مناهجه فى البحث بسبب ما نجم عنها من تحديات، باتت تهدد الوجود الاجتماعى لمجتمعنا، تبدت آثارها فى الثورة العلمية، والتكنولوجية التى أدت إلى تشكيل بيئات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تختلف عما خبرته المجتمعات فى مراحل سابقة، فى مقال بعنوان: التعليم ذلك الكنز المكنون، نشر بجريدة الأهرام 2006 لحامد عمار حول أهمية علم الإجتماع كتب يقول: (إن الاهتمام بعلم الاجتماع فى المرحلة التاريخية الراهنة تمثل التحدي الأساسي الذي يجب أن تضطلع به الجامعات، من حيث تطوير مناهجه، وأساليبه التدريسية في ضوء الملامح التي بدت في الوضعية العالمية التي أوشكت علي الانتهاء، من ترسيم حدودها، وقدراتها، وخصائصها، ومواصفاتها، ومصالحها، وقواها الإجتماعية، وبرز منهجها في السيطرة، والاحتلال متمثلاً في ثورة معرفية، حيث بات احتلال القدرات العلمية والتكنولوجيا والمعرفية، هي القوي المهيمنة بديلاً عن رأس المال التقليدي، وأخطر ما يبدو نتاجاً لهذا التحول هو أنه بالقدر الذي تمنحه هذه المعرفة للبشر من تقدم، بقدر ما يترتب عليها من مشكلات، وظواهر إجتماعية، تبدو التناقضات بينها صارخة)، فيبدو التشوه ماثلاً في طبيعة العلاقات الإجتماعية والأدوار والوظائف والمكانة والدخل، وحيازة القوة وهو ما يتطلب الإهتمام بالعلوم الإنسانية في أروقة الجامعات.
على أن دراسة سابقة نشرت عام 1999م قبل أن يقدم حامد عمار رؤيته لضرورة العلوم الإنسانية وضرورة مواجهتها للتحديات التى تواجهنا، بعنوان الفعل والتنظير الاجتماعى فى مؤتمر الوضع الحالى لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا أوضحت الدراسة أن الكثير مما نعرفه اليوم كآثار عملية تكنولوجيا، وترتيبات جديدة اقتصادية، وتوجهات لتصاعد انفتاح الجماعات الإنسانية علي بعضها البعض، إنما يعني معطيات تحولية، وظواهر جديدة تماما، وتحديات لمراجعة المفاهيم والنظريات، وهنا يجد علماء الإجتماع أنفسهم مواجهين بمراجعة قضايا، لم تكن في حسبان البشر من قبل، بل أن القضايا التقليدية، والظواهر المعتادة لا تستطيع المفاهيم المألوفة في العلم الإجتماعي، القدرة علي التصدي لها، مثل قضايا الاتصال البشري، والتطور الهائل الذي حدث في أساليبه، وتأثير ذلك علي الوعي الكوني إضافة إلي قضايا أخري، مثل تصاعد نخب العقل والمعلومات وتغير سريع في المهن والوظائف، ومفاهيم جديدة للأهمية، ووظائف جديدة للأسرة، وتشكل تنظيمات مجتمعية، تمارس تأثيراً علي أساليب الضبط الاجتماعي التقليدي.
ولعل هذه الأهمية التى يعول عليها بشأن العلوم الإنسانية، فى مواجهة التحديات التى تواجه مجتمعنا فى العصر الراهن تكشف عن أن القيمة الحقيقية لهذه العلوم تبدو، فى أن المعرفة التى ولدتها أصبحت ضرورية لأى مجتمع، بل وللإنسانية قاطبة، لأنها تنتمى إلى العقل المعرفى الذى ينهض على مبادئ العقل، وإخضاع الظواهر لقواعد المنهج العلمى، حال دراستها، ذلك المنهج الذى يربط ربطاً جدلياً بين تلك الظواهر، وبين سياقاتها البنوية، مما يجعلها تستجيب للتحديات والمشكلات المتجددة والمتغيرة، وقد يكون هذا وحده كفيلاً بأن دورها بات محسوماً وأصبحت لها وظيفة مشروعة فى بنية المعرفة من أجل مواجهة المشاكل والتحديات التى يفرضها التطور الصاعد دوماً فى حياة البشر.
إلا أن الوظيفة الأهم لهذه العلوم أنها تمثل خطاباً ثقافياً يحدد مسار الواقع، إذا كان خطاباً نقديا، وهنا نؤكد مع بيبر بورديو أحد فلاسفة العلوم الإنسانية أن العلوم الإنسانية هي أدوات لفهم العالم الإجتماعي علي المستوي الفردي، والمستوي العام، هذا الفهم يقدم للوعي العام للمجتمع أسس النضال والمقاومة، ضد كل أشكال الهيمنة، أي يسمح بالنضال ضد مفعول التطبيع الذي يهدف إلي جعل الصياغات الإجتماعية طبيعية. وصوتاً يضفي علي هذه العلوم وظيفتها في التغيير والإرتقاء للبشر، وللبيئة الإجتماعية، بسبب ما يمنحه ذلك الخطاب النقدي من فرصة لتغيير الوعي الزائف الذي تحرص الأنظمة السياسية علي شيوعه من أجل ضمان الإستمرار في الاستحواذ علي الثروة والسلطة.
كبوة الجامعة أم كبوة الوطن:
وقد تكون الإشارات السابقة، حول أهمية العلوم الإنسانية عموماً، وفي عصر العولمة على وجه الخصوص كفيلة بالرد علي الخطاب السياسي السائد حول عدم جدوى هذه العلوم، ومن ثم ينبغي عدم الاهتمام بها، بسبب عجز سوق العمل عن استيعاب خريجيها من كليات الأداب، والحقوق والتجارة، والتحول إلي اهتمام الجامعات بتدريس التخصصات الأكثر ربحية مثل البرمجة والحوسبة من أجل مواجهة البطالة لدي خريجي هذه الكليات.
قد يكون هذا التوجه مدخلاً لعلاج أزمة البطالة من وجهة نظر المطالبين به، والراغبين في مساره من أجل تجاوز أزمتنا الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يطرح سيلا من الأسئلة حول سبل تجاوز الأزمة بديلاً عن إلغاء هذه الكليات، أيضاً سؤال حول العلاقة بين إلغاء هذه الكليات التى تدرس العلوم الإنسانية، وبين مواجهة الأزمة المجتمعية الطاحنة التي نكابدها جميعهاً علي كافة الأصعدة.
بداية، يمكن التأكيد على أن الفهم الموضوعي للأزمة المجتمعية لدينا لا يتطلب رؤية إجرائية باستبدال تخصصات، ليست مطلوبة في سوق العمل وإحلال أخري تجد رواجا وطلبا عليها لمواجهة البطالة، هذا تبسيط مخل بل يتصف بالعجز، وعدم إدراك لإشكالية التغيير الحقيقية المطلوبة لتجاوز الأوضاع الراهنة التي تحاصرنا في إطار التخلف والتبعية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إن من يقصرون دور الجامعة وأهدافها كونها فقط تؤدي إلي إيجاد مكان في سوق العمل، وهو علي أي حال هدف له مشروعيته الاجتماعية، فإن هذا يمثل قصوراً مفاهيمياً حول ثقافة العلم والتعليم العالي تحديداً، ذلك التعليم يلعب الدور الأهم في اكتساب المعرفة والوعي، بالنسبة لكافة التخصصات، وبالتالي فإن تردي نوعية هذا التعليم تمثل الأساس في دوام حلقة التخلف، وهنا فإن اعتبار التعليم العالي قيمة تجارية، يباعد بين الجامعة كوسيلة للارتقاء والتحرر الإنساني، إلي دور الإتجار بوظيفة الجامعة لخدمة السوق، وليس لخدمة المجتمع.
نضيف إلي ذلك أن هذا المسلك التبادلي بين التخصصات العلمية في التعليم الجامعي، في هجرة بعض صنوفه، والتوسع في صنوف أخري، لا شك وأن هذا التوسع سيكون، توسعاً كمياً بمفهوم الربحية المطلوبة، وهو ما سوف يكون علي حساب النوع يضاف إلي حصائل التردى السائدة في الجامعات الان.
يجب أن نؤكد أن التعليم ليس نسقاً متعالياً يعمل في فراغ، بل هو نسق تتجذر أصوله، وتبني توجهاته، وتتحدد أهدافه، في إطار المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة، ومن ثم فهو أداة فعالة في مواجهة قضايا التغيير، والتحول الاجتماعي، وهنا فإن قدرة الجامعة علي أداء وظائفها وبين السياق الإجتماعي القادر علي إنجاز هذه الوظائف يجعلنا نتساءل: هل هناك علاقة بين الإنتاج العلمي والمعرفي وبين حيازة القوة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وبالذات في مجال العلوم الإنسانية، لا شك أن استقراء تاريخ الإنسانية يعزز من إيجابية السؤال ويؤكد أن ثمة علاقة جدلية بينهما، حيث يهيئ رصيد المعرفة المتنامي للمجتمع أسباباً للقوة، كما أن القوة تفسح المجال لمزيد من التراكم المعرفي، إلا أن توافر القوة والمعرفة مشروط هو الأخر بإطار عام لتفعيل تلك العلاقة الجدلية.
وهنا فإن أزمة الجامعة لدينا لا تتمثل في كون خريجيها يعانون من البطالة، بل الأزمة الحقيقية أن جامعاتنا وخاصة في مجال العلوم الإنسانية التي تطالب بإلغائها، لم تنجح في أن تنتج فكراً يكون أثره بادياً علي مجري التحول الإجتماعي والسياسي والاقتصادي.
لا ينبغي للجامعة أن تكون أداه لقمع إرادة المعرفة، بل أداه لتحرر العقل، وظيفة الجامعة هي تدمير العوائق المعرفية التي تعيق تقدم المجتمع، وظيفة العلوم الإنسانية هي كسر القوالب المعرفية الثابتة، والتي لم تعد تصلح لمواجهة الأزمة المجتمعية، من خلال منهج نقدي عقلاني.
لابد وأن نولي قدراً للأسباب الموضوعية التي أدت إلي تدهور التعليم الجامعي، ومازالت تهدد دور الجامعة في القيام بوظائفها وبدلاً من اللجوء إالي إلغاء تخصصات العلوم الإنسانية وإغلاق كليات الآداب وفرض القيود، أن نبحث عن بديل أخر لنواجه به كبوة المجتمع والجامعة معا.
وسأكتفي هنا بالسبب الأهم والذي لا يتهدد فقط الجامعة، بل يتهدد مستقبل الوطن برمته.
يتحدد هذا السبب بداية فيما يمكن أن نطلق عليه هيكل القوه القمعي سياسياً أو بنية الاستبداد أو ما يسمي بالفرعونية السياسية التي تتميز بحكم الفرد، والتي يمارس دورها علي أداء كل المؤسسات ويصيب المناخ العام بالجمود والتخلف ومقاومة التغيير، وعرقلة الحراك الإجتماعي علي كافة الأصعدة.
كما أن بناء القوة في الهرم السياسي هو بناء سلطوي، لا يعبر إلا عن المصالح العليا للطبقات صاحبة الثروة والسلطة، حيث تغيب اعتبارات الدفع بالحريات العامة، واستقلال مؤسسات الدولة خاصة الجامعات، التى تعد المصدر الأساسى لإنتاج الفكر النقدى الذى يدفع إلى التغيير.
وفي يقيني أن عملية بناء الطغيان السياسي، أو نظام الحكم القائم علي الفرد، طوال العقود الفائتة قد أولي للآداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي توجهات ذات أولوية لإشباع الحاجات الأساسية التي تتعلق فقط بحدود الحفاظ علي الجسد كالطعام والشراب، علي سوء حاله، الأمر الذي انعكس علي أداء وظائف الجامعة من النقد، وقياده عمليات التغيير، بل أن الجامعات قد لعبت الدور الأكبر في إعادة إنتاج الاستبداد، وصيانة هيكل القوة القمعي مما أفقد الجامعة إستقلالها، لقد أسهم غياب استقلال الجامعة، باعتباره الإنعكاس الموضوعي لعدم إستقلالية السلطات في ظل احتكار السلطة، إلي فساد الجامعة وفقدانها ريادتها، بسبب التدخلات الأمنية، بما يتلاءم وأهواء السياسة العليا في المجتمع، وفقدت الجامعة القيام بدورها التنويري من خلال نشر المعرفة النقدية التي تسهم في تأسيس معرفة علمية موضوعية قائمة علي العقل، وليس أهواء السياسة.
إن عدم تمتع الجامعة بالاستقلال من جانب الأنظمة السياسية المتعاقبة، مثل الضامن الوحيد لإعادة إنتاج الهيمنة علي المستوي الإجتماعي في المعترك السياسي، مما أدي إلي تأمين الصراع الاجتماعي لصالح القوة الاقتصادية والسياسية لا لصالح إثراء المعرفة وإيقاظ الوعي المجتمعي من خلال إيلاء الاهتمام للعلوم الإنسانية.
أيضاً لقد كان لكل هذه الأسباب، دور في غياب البيئة الحاضنة للبحث العلمي مما أثر علي دور الجامعات في قيادة التنمية الاقتصادية، وكما أفقد هيكل القوة القمعي دور الجامعة، في التحرر العقلي والفكري، فقدت الجامعة دورها في الإسهام في الإنتاجية الاقتصادية والرفاه المادي وفقد المجتمع دوره في الارتقاء برأس المال البشري والاستثمار فيه بما يقضي علي البطالة، ويؤسس للقدرات المتطورة للداخلين في سوق العمل.
إن الدعوة إلي إغلاق كليات العلوم الإنسانية هو بمثابة الاستمرار في النفق المظلم الذي أدي بنا إلي التخلف والتبعية، وما ترتب عليها من بطالة وسوء أوضاع.
إلا أن أهم ما يثير الاستغراب أن هذا الخيار يعنى فى التحليل الأخير انعدام المورث الثقافى للمجتمع، متمثلاً فى الأدباء والفنانين فى كافة المجالات، والمفكرين، فى كل المجالات، هذا التوجه لابد وأن يطرح تساؤلات لدى القائلين بتلك الدعوة بمقدمة هذه التساؤلات، نطرح مثلاً ما هو الموقف من وزارة الثقافة واستمرارها فى العمل، وآداء وظائفها التى حددها الدستور فى رعاية الفنون والآداب والإبداع.
ومن أين نأتى بالمبدعين والمفكرين بالشأن العام سياسياً واجتماعياً إذا ما تم إلغاء كليات العلوم الإنسانية؟ وما هو دور المجلس الأعلى للثقافة؟ وما هو الموقف من المواد الدستورية الخاصة بالمقومات الثقافية للمجتمع فى المادة 47 والتى تلتزم فيه الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية برواسبها الحضارية؟ فمن الذي سوف يساهم في تشكيل الهوية الثقافية، بعد أن يتم إلغاء كليات العلوم الإنسانية! وما هو الموقف من المادة 48 والتي تنص على أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية لمختلف فئات الشعب دون تمييز.
وسؤال نهائى وأخير وطرحه يستدعى معارك فكرية طويلة: ماذا نحن فاعلون إذا قدِمنا على إلغاء كليات الحقوق؟.
لا نستطيع أن نردد مع هذه الدعوة إلا أن نؤكد على تلك المقولة: (إذا لم تتقدم،
فأنت تتراجع وربما تتحلل)، وها نحن وبإجماع كل المهتمين والمتابعين أننا قد تجاوزنا التراجع بعد أن خرجنا من التاريخ، وأشرفنا على التحلل بعد أن صارت العلوم الإنسانية لا لزوم لها.
---------------------
بقلم: د. ثريا عبد الجواد *
* استاذ متفرغ لعلم الاجتماع بكليه الآداب جامعة المنوفية